ألف يوم ويوم من الجحيم.. كيف صنعت حرب السودان حياةً جديدة عنوانها النزوح والجوع والموت؟
08 يناير 2026

دخلت الحرب في السودان يومها الألف ويومًا إضافيًا، لتتحول من صراع مسلح إلى واقع يومي يعيد تشكيل معنى الحياة نفسها لملايين السودانيين. لم تعد الحرب مجرد أصوات رصاص أو خرائط نفوذ، بل صارت نمط عيش قاسٍ، تُدار فيه الأيام بالخوف، ويُقاس فيه الأمل بوجبة طعام أو شحنة هاتف أو دواء مفقود.
تختصر حكاية وداد عثمان جانبًا من المأساة الممتدة. في صباح بدا عاديًا، فتحت حقيبتها الصغيرة تبحث عن شيء يربطها ببيتها الذي غادرته مذعورة في الخرطوم بحري مع أطفالها، فلم تجد سوى مفاتيح صدئة بلا أبواب. بيتها، كما تقول، لم يعد بيتًا، فالمنازل صارت بلا أبواب، والعودة لم تعد خيارًا واضح المعالم. الهاتف المحمول، الذي لم يكن يومًا ترفًا، تحوّل إلى شريان حياة وحيد، تتلقى عبره تحويلات مالية صغيرة بالكاد تسد رمق يومها، لكن حتى ذلك أصبح معركة يومية في ظل انقطاع الكهرباء، والاضطرار لدفع ما تبقى من نقود لشحن الهاتف بالطاقة الشمسية.
حكاية وداد ليست استثناءً، بل مرآة لواقع يعيشه الملايين بعد أكثر من ألف يوم من الحرب. أناس نجوا بأجسادهم، لكنهم عالقون على حافة الخوف والجوع، متشبثين بخيط رفيع من المساعدات، وبذكريات بيوت لم تعد تشير إلى عنوان يمكن الرجوع إليه.
وبلغة الأرقام، التي لا تنقل الألم لكنها تكشف حجمه، تشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إلى أن نحو 33.7 مليون شخص داخل السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، أي ما يزيد على ثلثي السكان. أما أعداد النازحين واللاجئين، فقد تجاوزت 11.8 مليون شخص، وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ليصبح النزوح القسري أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
ولم يعد النزوح حدثًا استثنائيًا، بل تحول إلى “نمط حياة” مفروض. فالأسر التي لم تنزح بعد قد تُجبر على ذلك في أي لحظة، والنازحون أنفسهم يواجهون موجات نزوح متكررة بسبب القتال أو الحصار أو غياب الغذاء والدواء. يكفي أن تعجز الأسرة عن دفع إيجار، أو أن يتحول الخروج اليومي إلى مغامرة محفوفة بالموت، أو أن يصبح الطعام أزمة، لتبدأ رحلة نزوح جديدة.
الغذاء، أو بالأحرى غيابه، بات عنوانًا رئيسيًا للمأساة. الموائد السودانية التي كانت رمزًا للتكافل والتنوع، تحولت لدى كثيرين إلى وجبات فقيرة بلا قيمة غذائية، هدفها الوحيد إسكات جوع الأطفال. ومع اقتراب الحرب من عامها الثالث، تتفاقم الأزمة، إذ أعلن برنامج الغذاء العالمي اضطراره إلى تقليص الحصص الغذائية بنسبة تصل إلى 70% في المناطق المهددة بالمجاعة، و50% في المناطق المعرضة لها، مع تحذيرات من انقطاعات كاملة في الإمدادات حال استمرار نقص التمويل.
ولا يقل انهيار القطاع الصحي خطورة عن الجوع. فالموت لم يعد حكرًا على الرصاص، بل باتت أمراض بسيطة تفتك بالآلاف بسبب غياب العلاج. نساء يمتن أثناء الولادة، ومرضى مزمنون يفقدون حياتهم لعدم توفر الأدوية، وأوبئة مثل الملاريا وحمى الضنك تنتشر على نطاق واسع، بينما تعود أمراض كان يُعتقد أنها اندثرت، كالحصبة والسعال الديكي. منظمة الصحة العالمية حذرت من أكثر من 200 هجوم على منشآت صحية منذ اندلاع الحرب، ما جعل العلاج ترفًا نادرًا.
في خضم هذا الواقع القاتم، تغير معنى العيش نفسه. لم يعد الناس يحلمون بالغد، بل بإدارة يوم تحت الخوف. الصحافية عائدة قسيس سقطت ميتة فجأة في أم درمان، وسط أصوات الرصاص، في حادثة لخصها كثيرون بعبارة “قلب مفطور”. الخوف، ونقاط التفتيش، والابتزاز، والاعتقالات، دفعت الناس إلى تقليص حركتهم، وتأجيل العلاج، والاختيار بين المرض والطريق الأخطر منه.
ورغم ذلك، لم يخلُ المشهد من مبادرات أهلية، تمثلت في “غرف الطوارئ” و”التكايا”، التي أصبحت شريان حياة للآلاف. هذه المبادرات، المعتمدة على تبرعات المجتمع المحلي والمغتربين، أسهمت في إسعاف الجرحى، وتوفير الطعام والمياه، والحفاظ على قدر من التماسك الاجتماعي، وإن كان هشًا.
أما التعليم، فكان من أكبر الخاسرين. آلاف المدارس دُمّرت أو تحولت إلى مراكز إيواء، ونزح المعلمون، وتفرق التلاميذ، ليصبح الذهاب إلى المدرسة حلمًا بعيدًا في ظل الجوع والفقر. الجامعات بدورها توقفت أو تضررت، وضاعت سنوات من أعمار طلاب كانوا على أعتاب التخرج، ليضاف جيل كامل إلى قائمة الخسائر.
بعد ألف يوم ويوم من الحرب، يبدو السودان مثقلاً بأيام ثقيلة، تتراكم فيها الأسئلة بلا إجابات: لماذا تستمر الحرب؟ وكيف يمكن كسر حصار الجوع والمرض والخوف؟ وبين مفاتيح صدئة بلا أبواب، وهواتف تفتح نافذة ضيقة على الأمل، يواصل السودانيون صراعهم اليومي من أجل البقاء أحياء، في واحدة من أطول وأقسى المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
السودان حرب السودان ازمة انسانية النزوح في السودان الجوع والمجاعة الف يوم من الحرب

”سموم على المائدة”.. تراث مطروح الغذائي مهدد بالتلوث.. والإهمال يضرب السياحة

«عالم الروم» خارج نطاق الخدمة.. صرخات أهالي مطروح تتعالى ضد «فخاخ الموت» وإهمال الموظفين

تقرير: خامنئي يضع سيناريو الخروج إلى موسكو مع تصاعد الاضطرابات في إيران

صور| مطروح تستغيث: ”غزو” الباعة الجائلين يحول وسط البلد إلى ”مستنقع قاذورات”

عام تحت النار.. كيف حوّلت «الدعم السريع» السودان إلى ساحة مفتوحة للمجازر والنزوح؟
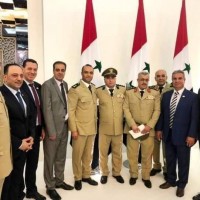
جنرالات من الظل.. كيف يخطط رموز نظام الأسد السابق لتمرد جديد في سوريا من المنافي؟

ملاك أراضى «جمعية طيبة» يستغيثون برئيس الوزراء لإنقاذهم من القرارات المتعسفة لجهاز مدينة الشروق

ملاك أراضى «جمعية طيبة» يستغيثون برئيس الوزراء لإنقاذهم من القرارات المتعسفة لجهاز مدينة الشروق

ملاك أراضى «جمعية طيبة» يستغيثون برئيس الوزراء لإنقاذهم من القرارات المتعسفة لجهاز مدينة الشروق

يحيى الشربيني يكتب: عام تحت المجهر: ماذا تغيّر فعلًا في سوريا بعد وصول الشرع؟

أمين الجبهة الوطنية بالعبور : مخالفات جمعية أحمد عرابي تقلل من أهميتها على خريطة الاستثمار الحقيقي

د. رقية عبدالحميد علي خبيرة التخاطب: العوامل البيئية والوراثية تقرر مستقبل أطفالنا اللغوي

تقرير شامل من قلب غزة: الجوع، الدمار، والانهيار الصحي

يحيى الشربيني يكتب : العملاء في ” غزة ”

من معتقل جنائي إلى زعيم ميليشيا مثيرة للجدل في رفح من هو ياسر أبو شباب ؟

منى تستقبل ضيوف الرحمن في يوم التروية إيذانًا ببدء موسم الحج 1446هـ

يحيى الشربيني يكتب :تاريخ العلاقات المصرية - الإيرانية وآخر التطورات

موسم حج 2025 – تنظيم محكم وإجراءات مبتكرة لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام

«الحروب اللامتماثلة: حروب العصر التي تحسمها التكنولوجيا» كتاب للدكتورة غادة محمد عامر

أين أموالنا؟.. صرخات عملاء «ذا مارك» العقارية تبحث عن منقذ

غرائب الحياة| .. باتا سيكا: العملاق البرازيلي الذي استخدموه في تخصيب النساء وأنجب أكثر من 500 طفل

هام قبل شراء أو بيع عقار.. خبير قانوني يقدم توصيات ومحاذير البيع والشراء للعقارات

لأول مرة في التاريخ|.. مونديال 2030 في ثلاث قارات.. المغرب وإسبانيا والبرتغال يظفرن باستضافة كأس العالم 2030.. وأولى المباريات في أوروغواي

«جمعية الكلح» تتألق بليلة محمدية في حب رسول الله

قرار مفاجئ فى أروقة نادى الزمالك

